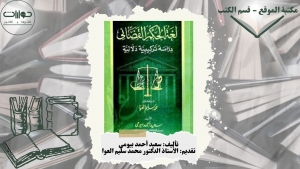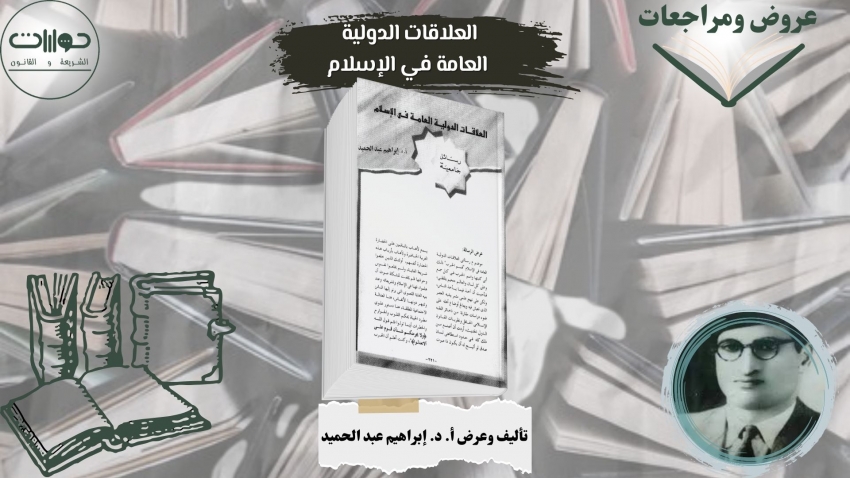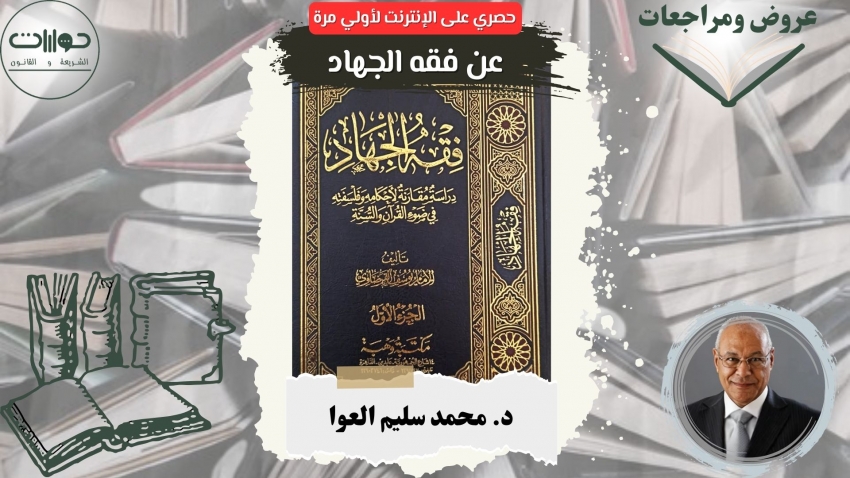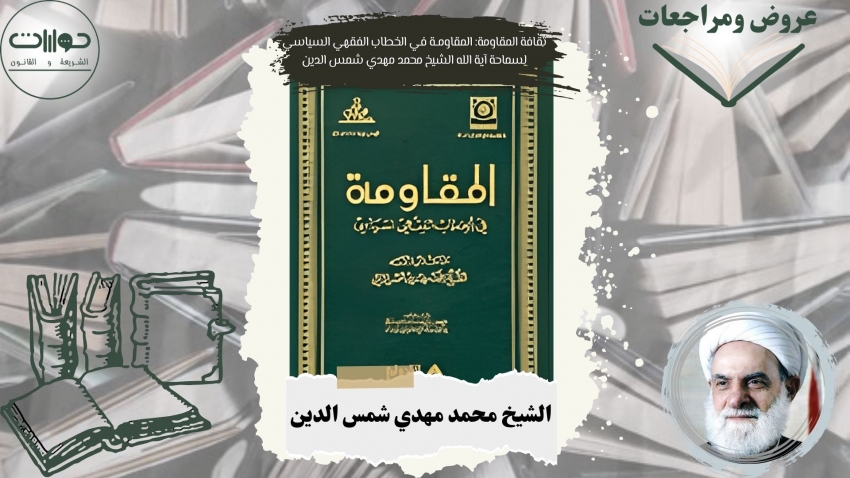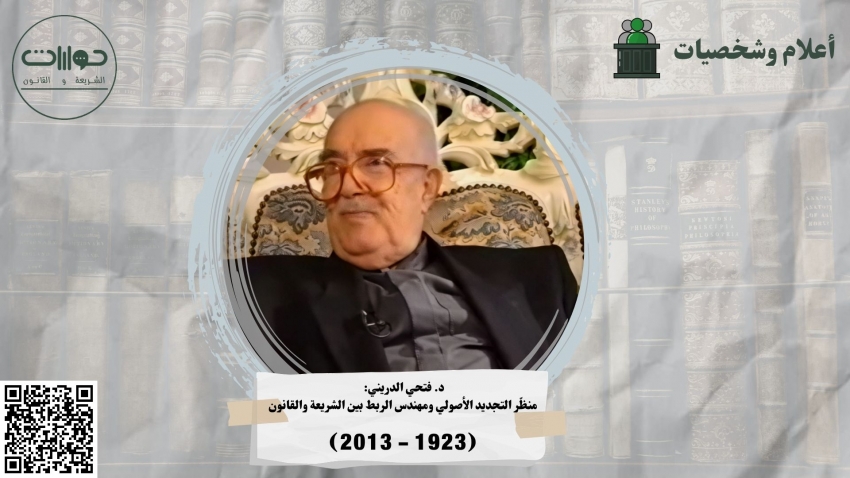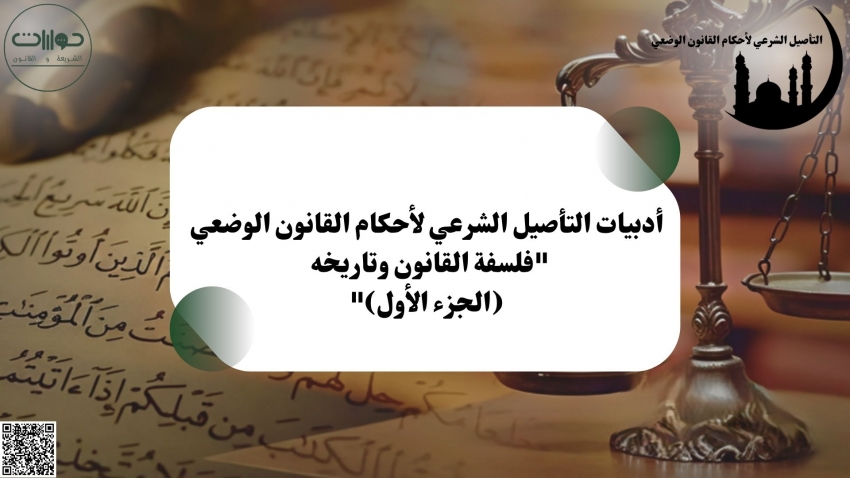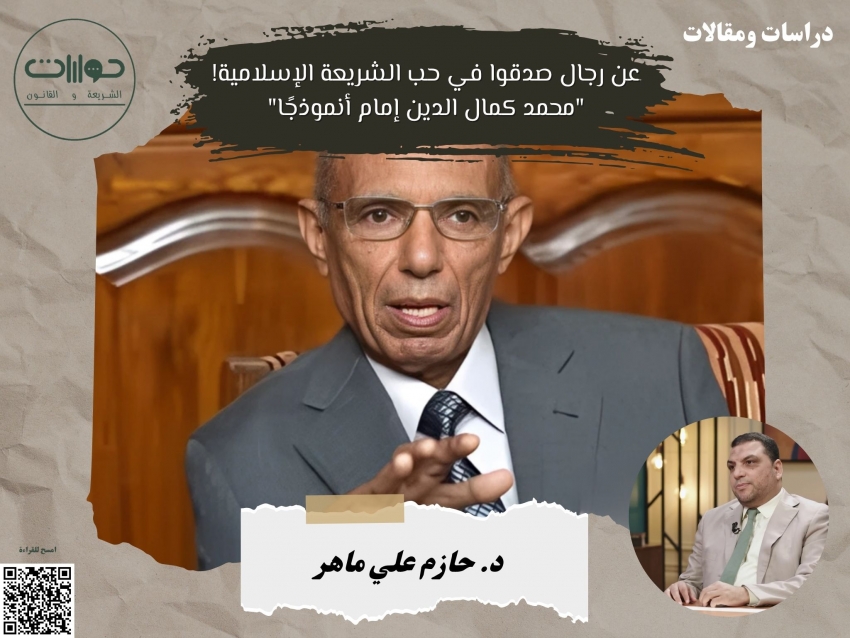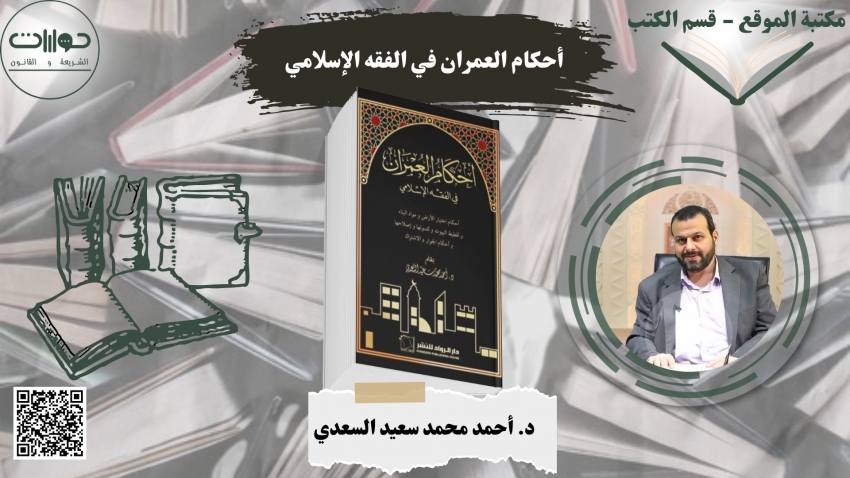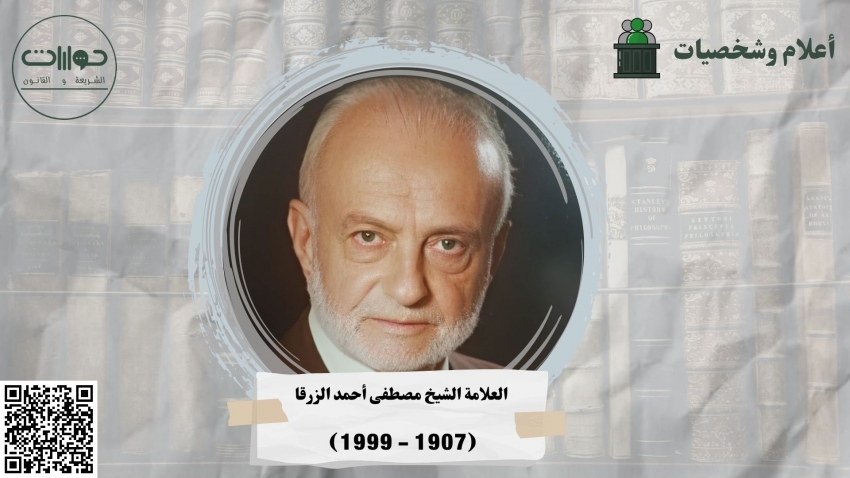صدر هذا الكتاب عن مكتبة الآداب بالقاهرة عام 1428ه/2007م، وهو في أصله رسالة ماجستير نوقشت بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وقد حصل الكاتب على جائزة اتحاد كتاب مصر عام 2006م. قدم لهذا الكتاب أستاذنا الدكتور محمد سليم العوا، حيث جاء في تقديمه ما يأتي:
"الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة.
والحقيقة بنت المداولة.
والمداولة تستلزم تبادل الرأي، وغالبًا ما تختلف فيها وجهات النظر، وانتصار إحداها على الأخرى لا يكون إلا بحجة قاطعة أو أقرب ما تكون إلى القطع، أو بفكرة مقنعة يتحول بسببها صاحب رأي إلى غيره، ويستقر بعد قبولها الرأي على قول فصل يصوغه كاتب الحكم القضائي في أسبابه التي تمهد لمنطوقه وتحمل ما يفصل به هذا المنطوق بين المتنازعين.
وإذا كانت المحاكم تشكل من دوائر تضم كل منها عددًا من القضاة يتداولون -بحكم القانون فيما يعرض عليهم من قضايا ليفصلوا فيها بين الخصوم؛ فإن الحكم تكتبه في النهاية يد واحدة يحمل سماتها وينطق بلسانها، وتَدَخُّلُ سائر أعضاء الدائرة القضائية في مسودة الحكم بتعديل عبارة، أو تغيير كلمة، أو تصويب جملة لا ينال من كونه، من حيث هو بنيان لغوي، نتاج عقل واحد وقلم واحد.
وللحكم أركان شكلية وأركان موضوعية أوجزهما قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفصلتهما أحكام المحاكم العليا في القضاء المدني والقضاء الإداري؛ أعني محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، فيما جرى عليه قضاؤهما من اشتراط سماتٍ في الأحكام تضمن ألا تكون قاصرة في أسبابها، أو فاسدة في استدلالها، أو غير ناطقة بالحجة التي تحمل قضاءها، وهذا الجانب من الأحكام القضائية محل دراسته في كتب القانون التي تعنى بالأحكام القضائية والمآخذ الشكلية والموضوعية عليها.
وبين أيدينا اليوم كتاب في جانب تأخرت العناية به جدًا في البحث اللغوي المعاصر، يدل على ذلك ندرة المراجع التي وجدها الكاتب في صلب موضوعه في المكتبتين اللغوية والقانونية، وهو كتاب يعنى بلغة الحكم القضائي التي هي نمط خاص من أنماط العربية الفصحى العصرية، وهو نمط كان يحتاج إلى دراسة بنيته التركيبية والدلالية دراسة ناقدة تبين خصائص لغة الحكم القضائي، والعوامل التي تؤثر فيه، والغايات التي يهدف الحكم المكتوب إلى تحقيقها، ومدى وصول الأحكام إليها.
وإذا كان المؤلف قد اختار القضاء الإداري مجالاً لبحثه، وحدد زمن البحث بخمس سنين [تبدأ من الأول من أكتوبر عام 1998، وتنتهي في الثلاثين من سبتمبر عام 2003]؛ فإن الأمثلة التي اختارها من قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية كانت أمثلة كافية -بالمعايير العلمية- لاستخلاص خصائص عامة، يصح القول بأنها مطَّردة للغة الحكم القضائي في أحكام مجلس الدولة.
وعلى الرغم من أن الكتاب يشبع حاجة المتخصص في علم اللغة، بإضافة بحث جديد إلى بحوثها المعاصرة فإنه يُثير أيضًا اهتمام المثقف العام بقدر ما يُثير اهتمام المتخصص في القانون بما يتضمنه من بحوث ذات أهمية لكل منهما.
فالمثقف العام سوف يقف عند بحوث لغة الصحافة ولغة الأحكام، وتأثير اللغات الأجنبية في لغة الحكم الإداري، والأساليب ذات الأصل الأجنبي، وتأثير اللغات الأجنبية في نظام الجملة القضائية، وتأثير العامية في لغة الحكم الإداري ونحوها.
والمتخصص في القانون سوف تستوقفه بحوث استخلاص الدلالات من أسباب الأحكام والقواعد المنطقية في الحكم القضائي، وضوابط تسبيب الحكم الإداري، وأصول استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية، والقواعد الكلية، وفن التفسير القانوني، وفهم الأحكام وأصول تأويلها، والوضوح والغموض في لغة الحكم القضائي وما إليها.
هذا كله فضلاً عما يجده المتخصص في علم اللغة من بحوث معمقة في بعض مباحث هذا العلم، ومن رجوع مستمر إلى أمهات الكتب الحديثة فيه دون إغفال لمراجعنا العربية الأصيلة في اللغة والفقه والتفسير على السواء.
ولقد أتيح لي أن أستمتع بمراجعة هذا الكتاب مرتين، أولاهما: عندما شاركت في الإشراف عليه ومناقشته حين قدمه مؤلفه لينال به درجة الماجستير في علم اللغة من كلية دار العلوم - حرسها الله - بجامعة القاهرة؛ وثانيتهما: عندما عنيت بكتابة هذا التقديم الوجيز له".
وقد أوضح المؤلف في تقديمه لكتابه الأهداف التي تغيَّاها في دراسته، وأوجزها فيما يأتي:
- وصف العربية المعاصرة –"وهي لغة فصحى مكتوبة تستخدم للتعبير عن الحضارة والثقافة المعاصرة في العالم العربي"- على المستوى التركيبي والدلالي من خلال دراسة الخواص التركيبية والدلالية للجملة في لغة أحكام القضاء بوصفها نمطاً مهماً من أنماط الفصحى المعاصرة.
- تعرف نماذج الجملة التي يكثر استخدامها في العربية الفصحى المعاصرة من خلال دراستها في لغة القضاء.
- الكشف عن جوانب التأثير والتأثر بين أنماط الفصحى المعاصرة لاسيما تأثر لغة الحكم القضائي بالسمات التركيبية للغة الصحافة المعاصرة.
- إلقاء الضوء على الدور الذي تضطلع به اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية في أحد مجالات التعامل بين الأفراد.
- بيان مدى انعكاس وضع اللغة في المجتمع على الأداء اللغوي لأحكام القضاء وإبراز الجوانب التي تسهم في تفعيل دور اللغة في العمل القضائي.
محتويات الكتاب:
- تعريف الحكم القضائي.
- المصطلحات المستخدمة في لغة الحكم القضائي.
- السياق اللغوي في الحكم القضائي.
- الباب الأول: السمات العامة للغة الحكم القضائي.
- الباب الثاني: الخواص التركيبية للجملة في لغة الحكم القضائي.
- الباب الثالث: الخواص الدلالية للجمة في لغة الحكم القضائي.
- خاتمة بأهم النتائج والتوصيات
- ملحق بأشهر الأخطاء والفروق اللغوية الواردة في الكتابة القضائية.
رابط مباشر لتحميل الكتاب